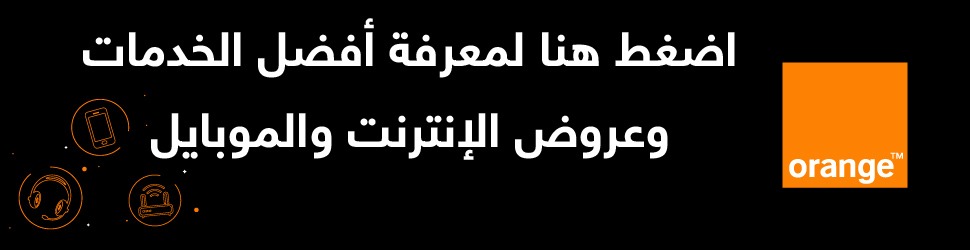فيلادلفيا نيوز
منذ أن خلق الله الإنسان، وهو في رحلة أزلية يبحث فيها عن كينونته وعن الحق الذي يمنح وجوده معنى، وعن الطريق الذي يقوده إلى نيل رضا خالقه، فظل قلب الإنسان عبر العصور متعطشًا إلى الصفاء الروحي والنقاء الداخلي الذي لا يجده في صخب المادة. ومن هذا التعطش الفطري، وُلد مفهوم التحنث، تلك الخلوة التي يختلي فيها المرء بنفسه أمام الله، وهي في جوهرها ليست فرارًا من الناس أو اعتزالاً للعالم هربًا من المسؤولية، بل هي اقتراب من الحق واكتساب للقوة الكافية لإعادة بناء النفس والروح من جديد. والتحنث في حقيقته ليس مجرد فعل خارجي يتمثل في الجلوس في مكان مقفر، بل هو رحلة داخلية عميقة يتحقق فيها الصمت الواعي، ويصفو فيها القلب من كدر المشغلات، ويقوى فيها الإيمان، ليعود الإنسان بعد ذلك إلى معترك الحياة حاملاً رسالته بحكمة ورحمة. ولعل أعمق تجليات هذه الرحلة وأكثرها إشراقًا في التاريخ الإنساني هي تلك الخلوات التي اتخذت من الجبال مسرحًا لها، تلك القمم الشامخة التي ارتبطت تاريخيًا بأسرار الوحي الإلهي، وقد ورد في الأثر الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان “يتحنث” في غار حراء، في أعلى جبل النور، حيث كان يجلس الليالي ذوات العدد يتأمل ويفكر ويتفكر، وهو النموذج الأسمى للتحنث الذي يجمع بين العبادة الذاتية والاستعداد النفسي لحمل أمانة الرسالة، وهذا يوضح أن التحنث منذ بداياته لم يكن مجرد عزلة جسدية عابرة، بل كان منهجًا تربويًا للتقرب إلى الله وتجهيز النفس لما هو أعظم.
إن اختيار الجبال بالذات لهذه الخلوات لم يكن أمرًا اعتباطيًا، فالجبال في الوجدان الروحي ليست مجرد تضاريس مرتفعة أو كتل صخرية، بل هي رمز للعلو المعنوي ووسيلة عملية لتعميق الصفاء الداخلي، فهي توفر الانعزال التام عن ضجيج الأرض وسفاسف الأمور، وتجبر الإنسان على مواجهة ذاته في صمت مهيب.
وقد أشار الفقهاء والمحققون، ومنهم الإمام ابن القيم في كتابه “مدارج السالكين”، إلى أن الاعتزال عن الناس في فترات محددة يُعد وسيلة ضرورية لتزكية النفس وإعداد القلب للتأمل، فالإنسان عندما يصعد جبلًا، يترك وراءه في السهل ضغوط الحياة ومشتتاتها، ويجد نفسه وجهاً لوجه مع سعة الأفق وضآلة حجمه الجسدي أمام عظمة الخلق، وهذا الصعود الجسدي يمثل استعارة بليغة للصعود الروحي، فالانكسار أمام عظمة الطبيعة يعلم الإنسان التواضع الحقيقي قبل امتلاك القوة، ويذكره بأنه جزء من ملكوت أكبر، مما يجعل اختيار الجبل جزءًا من منهج روحي عميق يهدف إلى صقل البصيرة قبل البصر.
وفي سير الأنبياء عليهم السلام، نجد التحنث والاعتكاف والتعبد بأوضح صوره، وكثيرًا ما كان الجبل هو الخلفية المهيبة لهذه المشاهد الروحية الفاصلة في تاريخ البشرية. فموسى عليه السلام اعتزل قومه أربعين ليلة على جبل الطور، في خلوة وصفتها النصوص القرآنية بأنها ميعاد مع الحق، حيث كان يتأمل في ملكوت الله ويستمد من هذه العزلة القوة الروحية الكافية لإحضار الشريعة وهداية بني إسرائيل، ولم تكن خلوته انقطاعًا عجزًا، بل كانت سبرًا لأعماق الروح واستعدادًا لتحمل ثقل التكليف، كما قال تعالى: “وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر”، فهذا الاستدعاء الإلهي لم يقع إلا بعد مرحلة من التهيؤ النفسي. وكذلك عيسى عليه السلام، الذي تذكر المصادر التاريخية والكنسية، ويؤيده السياق القرآني في زهده، أنه كان يجوب البراري والجبال وحيدًا، متأملًا في ملكوت السماوات، ناسكًا متبتلًا، يرى في عزلته قربًا من الحق ليتمكن من العودة برسالة نور ومحبة، وقد أشار الحافظ ابن كثير في “البداية والنهاية” عند حديثه عن قصص الأنبياء إلى أن الخلوة كانت دائمًا مقدمة لصقل النفوس واصطفائها للقيام بالبلاغ، مما يبرز الترابط الوثيق بين المكان الروحي والهدف الرسالي.
أما إبراهيم عليه السلام، إمام الحنفاء، فقد سلك مسلك التحنث الفكري والروحي حين خرج من قومه متأملًا في الكواكب والنجوم في صمت الليل، باحثًا عن خالق هذا الكون، حتى وصل إلى ذروة اليقين بقوله: “إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا”، مؤكدًا أن الخلوة هي بوابة الصفاء التي تسبق مواجهة العالم بالحق الصراح. وتصل هذه العلاقة بين الجبل والتحنث إلى ذروتها مع رسول الله محمد ﷺ في غار حراء؛ ذلك الكهف الصغير الضيق الذي يقع في قلب جبل النور، والذي يطل من خلاله المتأمل على الكعبة المشرفة من بعيد، فكان ﷺ يصعد ذلك الطريق الوعر وهو في سن الأربعين، ليجلس في صمت الغار يسمع صدى نفسه ويراقب النجوم ويتفكر في حال قومه والكون من حوله، وهذه العزلة التي سبقت نزول الوحي كانت تدريبًا إلهيًا للروح لتتحمل “قولاً ثقيلاً”، وقد وثق ابن عباس رضي الله عنهما والمؤرخون كابن إسحاق أن هذه الفترة كانت ساحة لتجهيز النفس المحمدية، مما يجعل من تجربة النبي ﷺ النموذج المعياري لفهم التحنث كعملية تكاملية تبدأ بالصمت وتنتهي بالعمل الإلهي لإصلاح الوجود.
لقد كان التحنث عند هؤلاء الصفوة وسيلة للتزود بالوقود الروحي قبل العودة لمواجهة أعباء الناس، ولم يكن قط هروبًا من المسؤولية، وهذا ما قرره الفقهاء المحققون كالإمام الغزالي في “إحياء علوم الدين”، حيث اعتبر أن العزلة المؤقتة ممدوحة لأنها تعين على التفكر الذي هو عبادة القلب، مع التنبيه على أن كمال الإنسان في مخالطة الناس والصبر على أذاهم بعد التزود من الخلوة. ومع ذلك، لم يخلُ هذا المسلك من منتقدين عبر التاريخ، فقد رأى بعض المعارضين أن الانقطاع عن الناس قد يؤدي إلى الانعزال السلبي، وانتقد بعض الصحابة والتابعين الإغراق في التبتل الذي يؤدي لترك الواجبات، ولكن الرد كان دائمًا بأن التحنث الشرعي هو “اعتكاف مؤقت” يهدف لترميم الروح وليس قطيعة أبدية مع المجتمع، فالتوازن بين الانعزال لتجديد النفس والعمل الاجتماعي لإصلاح الغير هو جوهر المنهج النبوي، وهو ما يمنح الإنسان التوازن النفسي والروحي قبل التصدي للمهام العظمى.
وفي الفكر الإسلامي اللاحق، اتخذ الزهاد والمتصوفة من التحنث طريقًا منهجيًا، واختاروا الجبال والقفار مسرحًا لمجاهداتهم، مستندين إلى أقوال مأثورة كقول الجنيد البغدادي: “من لم يخلُ بنفسه عن الخلق، لم يخلُ الله به”، وقول ابن عربي في “رسالة الخلوة” بأن العزلة هي ترك ما يشغل عن الحق، وهذا المنظور يرى في الجبل بصمته واتساعه مدرسة لتعلم لغة الصمت، وهي اللغة التي لا تدركها القلوب إلا حين تتخلص من ضجيج الأغيار. وفي المقابل، نجد في التراث المسيحي تجربة مماثلة بعمق، حيث عاش الرهبان والزهاد، وعلى رأسهم أنطونيوس الكبير، عقودًا في الجبال والكهوف طلباً للتجرد الكامل، وقد وثقت سير القديسين أن عزلاتهم كانت نوعًا من “الجهاد الخفي” ضد شهوات النفس، وكانوا يختارون الكهوف الجبلية لما توفره من حماية طبيعية وعزلة تامة، ورغم الانتقادات التي وجهت لهذا المسلك باعتباره يضعف الدور الاجتماعي، إلا أن التاريخ يثبت أن هؤلاء الزهاد كانوا يعودون كمرشدين روحيين يمنحون المجتمعات ثباتًا أخلاقيًا مستمدًا من تلك الخلوات.
إن التحنث في حقيقته ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة تقود إلى صفاء القلب وحضور الذهن مع الخالق، وقد روي عن العارفين كالشيخ عبد القادر الجيلاني أن الخلوة هي “حمية الروح”، فكما يحتمي المريض من الطعام ليصح جسده، يحتمي السالك من لغو الكلام وفضول النظر ليصح قلبه، والذين يظنون أن هذا المسلك نوع من الكسل يخطئون في فهم غايته الكبرى، فالإنسان الذي يختلي بنفسه يمارس أصعب أنواع المواجهة، وهي مواجهة عيوبه ونقائصه دون أقنعة اجتماعية. وقصص الصحابة رضي الله عنهم تؤكد هذا المنحى المتوازن؛ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يُعرف عنه فترات من الصمت والتأمل العميق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يختلي بنفسه ليحاسبها بشدة، وقد أشار الإمام النووي إلى أن هذه اللحظات من الانفراد كانت هي المصدر الذي يستمد منه هؤلاء القادة قدرتهم على العدل والحكمة بين الرعية، وكذلك الإمام الشافعي الذي كان يخصص وقتاً من ليله للخلوة مع العلم والعبادة، مما أنتج فقهًا رصينًا يجمع بين النص وروحانية المقاصد، وهذا يثبت أن التحنث بمفهومه الواسع هو انفصال مكاني أو نفسي مؤقت يتبعه اتصال نفعي دائم.
وفي العصر الحديث، ومع تسارع وتيرة الحياة المادية وتغول التكنولوجيا التي أفقدت الإنسان صمته، يصبح التحنث فعلاً ضرورياً لاستعادة التوازن، وقد وجدنا أمثلة لعلماء معاصرين كالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي كان يؤثر الخلوة في غرفته أو في أماكن هادئة ليتدبر معاني القرآن، مؤكداً أن “الفيوضات الربانية لا تتنزل إلا في سكون”، ورغم أن بعض المعاصرين يرون في هذا الانعزال ابتعاداً عن الواقع، إلا أن التجربة أثبتت أن الشخصية التي تملك نصيباً من الخلوة تكون أكثر قدرة على العطاء وأقل عرضة للاحتراق النفسي. إن التوجه المعاصر نحو الطبيعة والمرتفعات بحثاً عن الهدوء هو في الحقيقة بحث غريزي عن “التحنث” المفقود، حيث يجد الإنسان في صمت الجبل مرآة تعكس له ضآلة همومه اليومية أمام اتساع الكون، مما يعيد ترتيب أولوياته ويجعله أكثر استبصاراً بحقائق الوجود، فالجبل بجموده وعظمته يعلّم الإنسان لغة “الانتظار الصبور” ويذكره بأن الحقائق الكبرى تحتاج إلى وقت وصمت لتنضج في النفس، تماماً كما احتاج الأنبياء إلى سنوات من التأمل قبل إعلان الرسالة، ليظل التحنث بذلك رحلة إنسانية خالدة تتجاوز حدود الزمان والمكان، لتعيد صياغة الإنسان ليكون أكثر نقاءً وقرباً من خالقه.
وعليه، فإن التحنث يمثل تلك الحلقة المفقودة في سلسلة التكوين البشري المعاصر، إذ إنه يمنح المرء فرصة الانعتاق من أسر “الآنية” وضغط اللحظة الراهنة، ليدخل في رحاب الأبدية والتفكر في الغايات القصوى. ومن يمعن النظر في سيرة الصالحين والعلماء الذين أثروا في مسيرة الأمة، يجد أن عظمة نتاجهم لم تكن مجرد حصيلة قراءة واطلاع، بل كانت ثمرة لتلك الساعات الطوال التي قضوها في رحاب الخلوة، حيث تنكشف للقلب حقائق لا تدركها العيون الغارقة في التفاصيل اليومية. فالإمام الغزالي، على سبيل المثال، لم يكتب “إحياء علوم الدين” إلا بعد أن اعتزل الناس وجاب الفيافي وسكن المنارات، متحنثاً ومتعبداً، باحثاً عن اليقين الذي فقده في مجالس المناظرات، فكانت تلك الخلوة هي الجبل الرمزي الذي صعده ليعود منه بمشروع إصلاحي أحيا به أمة كاملة.
وهذا يقودنا إلى إدراك أن التحنث ليس مجرد انقطاع عن الحركة، بل هو حركة مكثفة نحو الداخل، وهو نوع من “الموت الاختياري” عن الشهوات والفضول قبل مواجهة الموت الحقيقي، ليكون الإنسان عندئذٍ أكثر استعداداً للحياة الحقيقية. وقد ذكر ابن القيم في “إغاثة اللهفان” أن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه بالذكر والخلوة، فإذا صفا القلب وتجلى، صار كأنه مرآة تبصر فيها حقائق الملكوت. ومن هنا يظهر الفرق الجوهري بين من يتخذ من العزلة وسيلة للهروب من الفشل أو الخوف من المواجهة، وبين من يتخذها وسيلة “للاستقواء بالحق”، فالأول يزداد وحشة وضياعاً، بينما الثاني يعود للناس بقلب أرحب وصدر أوسع، قادراً على احتواء آلام الخلق وتوجيههم بنور الله.
وفي سياق المقارنة الروحية، نجد أن هذه التجربة الإنسانية المتمثلة في طلب العلو والمكان المرتفع للتعبد قد تكررت في مختلف الثقافات، فبينما كان النبي ﷺ في غار حراء، كان الرهبان في جبال طور سيناء وفي صوامع الشام يبحثون عن ذات النور. وهذا يؤكد أن الجبل في تجربة التحنث يمثل “المعراج الأرضي” الذي يحاول من خلاله الإنسان ملامسة السماء بقلبه. إن الصمت الذي يوفره الجبل ليس صمتاً فارغاً، بل هو صمت ممتلئ بالهيبة، يسمح للإنسان بسماع “صوت الفطرة” الذي غطى عليه ضجيج المدنية. ففي الجبل، تذوب الفوارق الطبقية والاجتماعية، ويقف الإنسان بفقره وضعفه أمام غنى الخالق وقوته، فتتحطم أصنام الكبر والغرور التي قد تبنيها النفس في مجالس الجاه والسلطان.
إن هذا المنهج التربوي الذي أرسى قواعده الأنبياء عليهم السلام، وأكده العلماء والزهاد، يظل هو الترياق الوحيد لموجات القلق والاكتئاب والضياع التي تضرب المجتمعات الحديثة. فالتحنث يعيد للإنسان “مركزية الخالق” في حياته، ويخرجه من ضيق نفسه إلى سعة رحاب الله. واليوم، ونحن نعيش في عالم أصبح فيه التواصل الرقمي يطاردنا حتى في مخادعنا، تبرز أهمية “الخلوة المقننة”، أو ما يمكن تسميته بـ “تحنث الساعة”، حيث يقتطع الإنسان من وقته لحظات يغلق فيها كل نوافذ الدنيا ويفتح فيها نافذة قلبه نحو السماء، ليعيد ترتيب أوراقه المبعثرة ويحاسب نفسه قبل أن يُحاسب.
يظل التحنث دعوة خالدة لكل نفس تبحث عن الصفاء، ولكل عقل يطمح للرشاد. إنه فعل ثوري يرفض استلاب الروح، ويؤكد أن الإنسان ليس مجرد ترس في آلة اقتصادية، بل هو كائن روحي مكلف بأداء أمانة كبرى. والجبال، تلك الأوتاد الصامتة، ستبقى تذكرنا دوماً بأن هناك “أفقاً أعلى” يجب أن نطمح إليه، وبأن الخلوة الصادقة هي التي تنتهي بالخدمة الصادقة، وبأن غار حراء لم يكن مجرد مكان للتعبد، بل كان نقطة انطلاق للنور الذي أضاء ظلمات الدنيا. فمن أراد أن يغير العالم، فعليه أولاً أن يغير ما بنفسه في خلوة صدق، ومن أراد أن يقود الناس، فعليه أن يتعلم أولاً كيف يقود نفسه في دروب الصمت والتأمل، ليكون عمله بعد ذلك نوراً على نور، وبصيرة تهدي الحائرين في دروب الحياة الوعرة، تماماً كما كانت أنوار الوحي التي تفجرت من غار حراء، هداية ورحمة للعالمين، لتستمر مسيرة التحنث كمنهج حياة يبني الإنسان ليحمي البنيان، ويصل الأرض بالسماء في وحدة وجدانية لا تنفصم.
وعلى هذا الأساس، يستمر هذا المنهج في التبلور كضرورة شرعية وروحية، مدعومة بنصوص واضحة وآثار ثابتة تؤكد أن الخلوة لم تكن يوماً غاية في ذاتها، بل وسيلة لغاية أسمى. ويؤكد الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه “فتح الباري بشرح صحيح البخاري” عند شرحه لحديث التحنث، أن اختيار الخلاء حُبب إلى النبي ﷺ لأن مع المخالطة تشاغل القلب، فإذا انقطع عن الشواغل أقبل على الله بكليته، وهذا ما يسمى عند المحققين بـ “تخلية القلب للتحلية”. وهذا التوثيق يزيل اللبس عما يظنه البعض من أن التحنث كان مجرد عادة جاهلية، بل هو فعلٌ نبوي أقره الإسلام وهذبه ليكون “اعتكافاً” شرعياً يقوم على العلم والعمل.
وفي استحضار النماذج الموثقة من التابعين، يبرز اسم الإمام سفيان الثوري الذي كان يقول: «هذا زمان العزلة، والزم بيت القعر»، وهذا القول الذي نقله أبو نعيم الأصبهاني في “حلية الأولياء”، لم يكن دعوة للكسل، بل كان تشخيصاً دقيقاً لفساد بعض الأزمنة التي تصبح فيها الخلوة حصناً للدين. وبالمثل، نجد أن الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، كان يرى في الانقطاع المؤقت عن الناس وسيلة لمراجعة الحديث وحفظه، مما يربط بين التحنث الروحي والتحصيل العلمي، مؤكداً أن الصمت هو “زينة العالم في المجالس، وستره عند الجهل”.
وإذا انتقلنا إلى توثيق هذه الحالة في سياق المقاصد الشرعية، نجد أن الإمام الشاطبي في كتابه “الموافقات” يشير إلى أن التكاليف الشرعية جاءت لإخراج المكلف عن ندائه وهواه، ولا يتحقق ذلك إلا بنوع من المجاهدة التي تعد الخلوة ركناً أساسياً فيها. فالمسلم الذي يقتدي بتحنث النبي ﷺ في حراء، يمتثل في الحقيقة لمنهج “التزكية” الوارد في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ [الشمس: 9]، والتزكية تحتاج إلى “معمل روحي” بعيد عن المؤثرات الخارجية، وهو ما توفره الجبال والقفار وأماكن العبادة المنعزلة.
أما في مدرسة السلوك، فقد وثق الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه “الغنية لطالبي طريق الحق” أن الخلوة لها شروط وأركان، أولها العلم، فمن اعتزل بغير علم أفسد أكثر مما أصلح. وهذا يؤكد أن التحنث الإسلامي الموثق يختلف عن الرهبانية المبتدعة؛ فالتحنث هنا هو “خلوة العارف” التي تزيد بصاحبها شعوراً بالمسؤولية تجاه الأمة، لا “خلوة الجاهل” التي تورث الكبر أو الانفصال عن الواقع. وقد نقل ابن القيم عن بعض العارفين قوله: «العزلة عن الجاهل حضرة القرب، والعزلة عن العالم فتنة»، مما يوضح أن الهدف هو الوصول إلى “خلوة القلب” حتى وهو وسط الزحام.
وفي العصر الحديث، نجد أن التوثيق العملي لهذا المنهج ظهر في كتابات المفكرين الإسلاميين الذين عاينوا صراعات المادة، مثل الشيخ محمد الغزالي في كتابه “جدد حياتك”، حيث ربط بين السكينة النفسية وبين اللحظات التي ينفرد فيها الإنسان بخالقه، معتبراً أن غار حراء هو “المدرسة الأولى” التي تخرج منها أعظم قادة التاريخ، لأنهم تعلموا فيها كيف يسودون أنفسهم قبل أن يسودوا غيرهم. وهذا التواتر في الإشادة بالخلوة عبر العصور، من الصحابة إلى التابعين وصولاً إلى علماء العصر الحديث، يقطع بأن التحنث ضرورة وجودية لا غنى عنها لمن أراد سلوك طريق الحق.
وختاماً، فإن رحلة التحنث الموثقة تاريخياً وشرعياً تنتهي دائماً بالعودة إلى المجتمع بقلب سليم وبصيرة نافذة، فكل من صعد جبل النور بصدق، عاد منه بنور يسعى بين يديه. إنها دعوة لاستعادة “الأدب مع الله” في ساعات الخلوة، واستحضار عظمة الخالق في صمت الليل، ليكون لكل مسلم نصيبٌ من غار حراء في قلبه، يفر إليه كلما اشتدت عليه كربات الدنيا، مستمداً من تلك العزلة القوة واليقين، وموقناً بأن “من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟”، لتظل هذه التجربة هي الجسر الموثق بين فناء المادة وبقاء الروح، وبين تراب الأرض ونور السماء.
لقد كان التحنث منذ الأزل محطةً ضرورية في رحلة الإنسان نحو خالقه، وهي رحلةٌ تبدأ بالفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، فإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام، أبو الأنبياء وأسوة الحنفاء، يخرج في ظلمات الليل يتأمل في ملكوت السماوات والأرض باحثاً عن بارئها، حتى اهتدى إلى اليقين وقال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، فإن هذه الرحلة لم تنقطع، بل استمرت سنَّةً روحية في نفوس الصفوة، لتتوج بأكمل صورها في خاتم النبيين وسيد المرسلين، محمد ﷺ، الذي كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، حتى أتاه اليقين من ربه، فكانت تلك الخلوة المباركة هي المعمل الذي تهيأت فيه النفس المحمدية لتلقي أعظم رسالة، لتكون هذه البداية الإبراهيمية وذلك الختام المحمدي بمثابة النغمتين الأساسيتين في سيمفونية التحنث الخالدة عبر الزمان.
ولم تكن هذه السنة الروحية وقفاً على الأنبياء وحدهم، بل هي نزعة فطرية تجلت في نفوس عدد من أعلام قريش الذين نبذوا عبادة الأصنام وطلبوا الحنيفية ملة إبراهيم، فكان عبد المطلب بن هاشم، سيد قريش وجد النبي ﷺ، يعتكف في غار حراء في شهر رمضان، يتعبّد ويتأمل، وورقة بن نوفل، الحكيم المطلع على الكتب، والذي تنصّر ورفض ظلمات الجاهلية، كان يتحنث في نفس الغار وفي غيره، يبحث عن نور الحق، وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل، الذي رفض اليهودية والنصرانية والأصنام، وكان يدعو في خلواته: “اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك به”، فقبض على الفطرة السليمة قبل البعثة، وحكيم بن حزام، وابن عم السيدة خديجة، الذي نشأ في حجرها وعُرف بحكمته وتأمله، وأبو أمية بن المغيرة، الملقب بزاد الركب لجوده، وزوج عاتكة بنت عبد المطلب، الذي كان من المتحنثين الباحثين عن دين إبراهيم. فهؤلاء النفر، برغم اختلاف مصائرهم، شكلوا ظاهرة روحية متميزة في مجتمع مكة، تدل على وجود قلوب لم تلوثها تماماً ظلمات الوثنية، وكانت تتحسس طريق الحق في صمت الجبال وخلوات الكهوف، حتى إذا بزغ فجر الإسلام، كان بعضهم أول المؤمنين، وبعضهم مات على الحنيفية منتظراً.
وهنا يبرز عبد المطلب، جد النبي محمد ﷺ، كأحد أبرز رموز تلك المرحلة الروحية التي سبقت البعثة. فقد كان من قادة قريش في الجاهلية، وعُرف بـ “التحنث” والتفكر في غار حراء قبل الإسلام. وكان تحنثه يتمثل في الخلوة للعبادة والتفكر، خاصة في شهر رمضان، مبتعداً عن الأصنام والشرك، مما يدل على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. وقد روى الإمام البيهقي في “دلائل النبوة” وغيره أن عبد المطلب كان يتحنث في غار حراء، وذكر ابن هشام في “السيرة النبوية” أن عبد المطلب أول من تحنث في حراء من قريش، وتبعه آخرون. وبعد وفاته، تولى تربية النبي ﷺ عمه أبو طالب، وكان يخرج معه أحياناً في رحلات التحنث، فاستمر النبي ﷺ على هذه العادة قبل البعثة، مما يدل على أنها عادة متوارثة في أسرته الطاهرة.
لم يكن عبد المطلب يعبد الأصنام خلال فترة تحنثه، بل كان يدعو الله وحده، مما يعكس وجود “الحنيفية” في بعض العرب، أي البقايا التوحيدية من دين إبراهيم عليه السلام. وقد ورد في السيرة أنه نذر إن رزقه الله عشرة أبناء لينحر أحدهم، ثم فداه بمائة من الإبل، وهي قصة تعكس تقربه بالذبح لله لا للأصنام. وهكذا، فإن تحنث عبد المطلب كان عبادة على منهج غير كامل، لأنه لم يتبع شريعة موسى أو عيسى عليهما السلام، لكنه كان بحثاً صادقاً عن الدين الحق ورفضاً لشرك قومه، فكان تحنثه تمهيدًا تاريخيًا ونفسيًا لبعثة النبي ﷺ، إذ حفظت أسرته مكان العبادة (حراء) وتقاليد التوحيد الجزئي، حتى جاء الإسلام مكتملًا على يد حفيده، خاتم النبيين محمد ﷺ، فكان ذلك من حكمة الله في تهيئة الظروف الروحية والبيئية للنبوة.
وقد أكد المؤرخون والمحدثون هذه الحقيقة، ومنهم ابن كثير في “البداية والنهاية”، والطبري في تاريخه، والبيهقي في “دلائل النبوة”، وابن الأثير في “الكامل في التاريخ”. بل إن الإجماع التاريخي انعقد على أصل القصة، وإن اختلفت بعض التفاصيل الجزئية، فهي من الأخبار المتواترة معنويًا، المنقولة في مصادر السيرة الأولى. ويعتبرها مؤرخو السيرة حقيقة تاريخية ثابتة، لأنها تتناسب مع السياق التاريخي لبقايا الحنيفية في مكة، ولها علاقة مباشرة بتأهيل البيئة لنبوة محمد ﷺ، فتتحول خلوة عبد المطلب من مجرد فعل تعبدي فردي إلى لبنة في بناء الإرث الروحي الذي مهّد لظهور الوحي الخاتم.
ولعل في هذا الامتداد بين تحنث عبد المطلب في غار حراء، وتحـنث النبي ﷺ فيه بعده، دلالة على الاستمرارية الربانية التي تصنع القلوب قبل أن تنزل الشرائع، فالغار ذاته الذي شهد خلوة الجد الباحث عن الحق، شهد بعد عقود نزول أول آيات النور على الحفيد، فالتقت الحنيفية الناقصة بالرسالة الكاملة في مكان واحد، ليكون غار حراء شاهداً على أن التحنث كان ولا يزال الطريق الأقصر إلى الله، والجسر الذي يصل بين صفاء الفطرة ونور الوحي، وبين صمت الجبل وكلمة السماء.
وتمر الأيام متوالية في تقويم العرب قبل الإسلام، الذي كان تقويماً قمرياً يرتبط بمنازل القمر وأحوال الطقس والحمل. فلم يكن لشهر الصيام الذي نعرفه اليوم باسم “رمضان” هذا الاسم وحده في جاهلية العرب، بل تشير المصادر التاريخية إلى أنه عُرف بأسماء أخرى متعددة، كل اسم يحمل بصمة زمنه وبيئته. فقد ذكر المؤرخون واللغويون، كالطبري في تاريخه وابن حزم في “جمهرة أنساب العرب” وأبي منصور الثعالبي في “فقه اللغة”، أن للشهور العربية أسماء قديمة تغيرت بمرور الزمن. وكان الشهر المعروف الآن برمضان يُدعى في تلك الأزمنة غالباً “ناتِق” (وبعض الروايات تسميه “نافق”)، وربما اشتُقّ من النَّتْق الذي يعني النبش أو التحريك، في إشارة محتملة إلى بداية حركة النبت أو نشاط القبائل. كما سُمّي أيضاً “زاهر”، وصفاً لحال الأرض. وقد ورد في بعض الروايات اسم “نَفِر”، المشتق من النَّفْر الذي يعني الارتحال أو شدة الحر، في إشارة إلى وقوعه في فترة القيظ أو كونه موسماً للترحال.
هذه الأسماء – ناتق، زاهر، نافر – كانت مرآة لعالم العرب قبل البعثة، عالمٍ ارتبطت مفرداته بالطبيعة القاسية وبسياق حياة البداوة والتنقل. وظلت هذه التسميات مستخدمة حتى جاء الإسلام وحَوَّل مسار الزمن وملأه بمعانٍ جديدة. ففي السنة الثانية للهجرة، نزل التكليف الإلهي بالصيام، ونزلت الآية الكريمة: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} (البقرة: 185). حينها، انسلخت الأسماء القديمة بكل ما تحمله من دلالات الجاهلية المادية، ليستقر الاسم “رمضان”، مُكتسباً حمولة روحانية هائلة. والاسم مشتق من “الرَّمَض” وهو شدة الحر، لكنه لم يعد حرّ الشمس والرمل، بل تحول ليصبح رمزاً لحرقة الشوق إلى المغفرة، وحرقة جمرات التقوى في قلوب المؤمنين، وحرّ الذنوب وهي تذوب في بوتقة الطاعة والعبادة. وهكذا، تحوّل شهر “ناتق” أو “نافر” الجاهلي، بكل ما فيه من معاني الأرض والسماء القديمة، إلى “رمضان” الإسلامي، شهر الصوم والقرآن والرحمة، ليصبح الزمان نفسه شاهداً على أعظم تحوُّل في تاريخ البشرية، حيث تُغيّر الاسم والمسمى معاً.
إذن، رحلة الإنسان نحو الله، نحو الصفاء، نحو القلب النقي. هو لحظة يتوقف فيها المرء عن الصخب الخارجي، ويستمع إلى صوته الداخلي، ويعيد ترتيب أموره. هو مواجهة مع النفس قبل مواجهة الناس، وعمل داخلي قبل عمل خارجي، وهو ما يميّز التحنث عن الانعزال السلبي. إن من يتحنث يصبح قادرًا على الإصغاء للحق، على محبة الناس، على مواجهة الحياة بقوة صادقة، بعيدًا عن الغرور أو الخوف. هو يزيل شوائب قلبه، ويستعيد النور في داخله، ليعود إلى الدنيا محملاً بالحكمة، ليكون ناصحًا، داعيًا، عاملًا بالخير، هادئًا ومستبصرًا. وهنا يظهر الفرق بين من يستخدم التحنث هروبًا، وبين من يستخدمه عبادة وخلوة ووسيلة لتقوية القلب، والعودة إلى الناس برسالة صادقة. والجبل في هذه الرحلة هو ذلك الصديق الصامت الذي لا يعطي إجابات جاهزة، بل يطرح أسئلة عميقة تهز أعماق الإنسان.
وهكذا يمضي سيل التحنث متدفقاً عبر العصور، من بدايته الإبراهيمية، مروراً بخلوات قريش الحنفاء، ووصولاً إلى تجليته الكاملة في سيرة النبي الخاتم ﷺ، ليتشعب بعد ذلك إلى روافد متنوعة: من خلوة البدوي في الصحراء بحثاً عن الصفاء والسكينة بعيدا عن صخب المدينة وترفها وضجيجها حيث يمضي الليالي والأيام بمفهومه البسيط ، إلى اعتكاف العالم في محرابه طلباً للإلهام، إلى خروج الأمة للصلاة في العراء تذكيراً بالانتماء إلى السماء، فتبقى هذه السنة الروحية هي الجسر المتين الذي يصل الأرض بالسماء، والمحوّل الذي يغير طاقة الصمت الواعي إلى قوة فعل مؤثرة، فيعود الإنسان من عزلته المباركة إلى الناس بحكمة الرحمن، وبصيرة النور، وقوة الإيمان، ليكون كما أراد الله له: خليفة في الأرض، عاملًا بإذن ربه، مصلحًا بما أُوتي من قوة، مستمدًا تلك القوة من تلك اللحظات الخاليات التي يخلو فيها بين يدي الملك العظيم.
وهي وهبة من الله واصطفاء ليس كل عبد لله قادر أن يؤديها أو يفهمها أو ييسر لها فهي رياضة وترويض وعبادة وتأمل وتطهير النفس من رواسب الذنوب والنزوات والآثام وزيادة شحن الإيمان واليقين والقرب من الله، وزيادة طاقة اليقين فيخرج وقد صفا قلبه، واستنار باطنه، وانسلخ من أمراضه القلبية والنفسية والخلقية إن صح توجهه إلى الله، وخلصت نواياه في خلوته، بل إنه لينسلخ تبعًا لهذا من بعض أمراضه الجسمية والبدينة كذلك، فكأنما ولد ولادة أخرى إن وفقه الله خلوة فهي نوع من عزل المريض حتى يشفى وشر الأمراض أمراض الباطن، وشر الآثار آثارها المدمرة، وشر الموتى موتى الأحياء.
وفي الختام، يظل التحنث دعوة خالدة للإنسان كي يجلس مع نفسه، يستمع إلى قلبه، ويقترب من خالقه، ليعود بعد ذلك إلى الحياة حاملاً نور الحكمة والصفاء. إنه ليس هروبًا من الناس أو الواقع، بل طريق للتجدد الداخلي، وإعداد النفس لمواجهة ضغوط الحياة بالهدوء والحكمة. التحنث يعلم الإنسان الصبر، ويقوي قلبه، ويجعله أكثر قدرة على الحب والعمل والخدمة. ومن يعرف قيمة الخلوة ويمارسها بوعي، يصبح قادرًا على تحويل صمته إلى قوة، وعزلته إلى نور، وخلوته إلى رسالة تحملها لكل من حوله. والجبال تذكرنا دائمًا أن الطريق إلى القمة شاق، ولكن المنظر من الأعلى يستحق كل هذا العناء. التوازن بين الخلوة والعمل، بين الصمت والقول، بين التأمل والخدمة، هو مفتاح النجاح في هذا النهج. فكما نرى من تجارب الأنبياء والصالحين والمتصوفة والمعاصرين، فإن التحنث الحق يربط الإنسان بخالقه، ويجعله أكثر إنسانية، وأكثر حكمة، وأكثر قدرة على مواجهة الحياة بروح متجددة ونور داخلي لا ينطفئ. إنه رحلة دائمة من الداخل إلى الخارج، من الصمت إلى العمل، من الوحدة إلى المشاركة، ومن الظل إلى النور. والجبل في هذه الرحلة هو المحطة التي يتزود فيها المسافر بالماء الروحي قبل أن يعود إلى صحراء العالم.
التحنث إذن ليس مجرد فعل، بل هو حياة كاملة، وسلوك متكامل، وطريق للتجدد الروحي الذي يجعل الإنسان في كل عصر أكثر قدرة على فهم ذاته، وعلى رؤية العالم بصفاء، وعلى نشر الخير بين الناس بحكمة ورحمة. والجبال، بما تحمله من تاريخ مقدس وصمت بليغ، تظل مدارس مفتوحة لمن أراد أن يلتحق بهذه الجامعة الإلهية، حيث يكون الدرس الأول هو التواضع، والامتحان هو الصبر، والنتيجة هي القرب من الله. فمن صعد جبل التحنث بإخلاص، نزل منه بشيئين: غبار الطريق على قدميه، ونور الحكمة في قلبه.

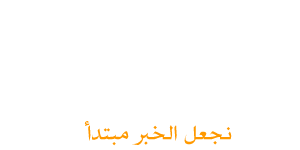 فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ