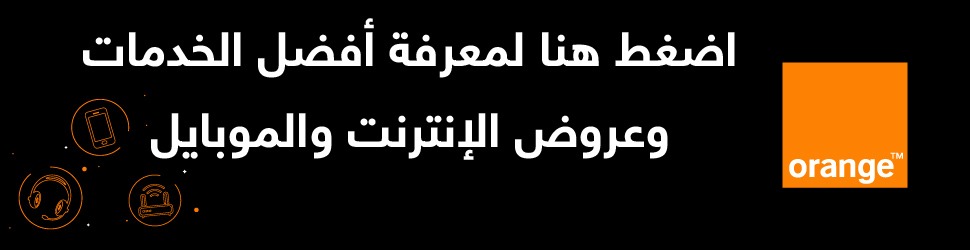فيلادلفيا نيوز
بقلم: الشريف خالد الأبلج
شكّلت شخصية محمد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور البغدادي النيسابوري، المعروف بابن المجاور، إشكالية تاريخية ومنهجية تستحق الدراسة المتأنية. فمن خلال تتبع المصادر الأولية والمراجع العلمية يمكننا الكشف عن حقيقة هذه الشخصية وتقييم منهجها في كتاب تاريخ المستبصر. وحين يُطرح اسم ابن المجاور في الأوساط العلمية، يثور جدل كبير حول حقيقة هذه الشخصية: هل هي شخصية حقيقية عاشت وتركت أثراً، أم هي شخصية خيالية اختلقها بعض المؤرخين؟
وبعد بحث طويل في المصادر والمراجع، يمكنني القول بأن ابن المجاور شخصية عاشت في القرن السابع الهجري، لكنها بقيت غامضة بسبب قلة المعلومات الموثقة عنها. أما نسبه الحقيقي، فهو محمد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور، وينتهي نسبه إلى بغداد ونيسابور، وهما من الحواضر العلمية الكبرى في خراسان والعراق. وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ ميلاده ووفاته بدقة، مما أضاف غموضاً حول شخصيته. وبحسب ما ورد في معجم البلدان لياقوت الحموي (ج1، ص482) وكشف الظنون لحاجي خليفة (ج1، ص314)، فإن ابن المجاور ينتمي إلى أسرة علمية معروفة بالاشتغال بالعلم والرحلة والتجارة.
ومن هنا تبدأ إشكالية ابن المجاور من هذا الاضطراب في النسب، إذ لم تتفق المصادر القديمة على تحديد أصله بدقة. فبعض المؤرخين نسبوه إلى البصرة، وآخرون إلى اليمن أو عمان، في حين عدّه آخرون فارسياً الأصل نشأ في بيئة عربية.
هذا التعدد في الانتماءات الجغرافية والثقافية يعكس منذ البداية ضعف التوثيق التاريخي لشخصيته، ويجعل دراسة فكره عملاً أقرب إلى التحقيق الأثري منه إلى التوثيق السردي. أما عن مولده ووفاته، فإننا أمام ضبابية زمنية واضحة؛ فبعضهم يذكر أنه وُلد في أواخر القرن السادس الهجري وعاش حتى منتصف السابع، في حين تذهب تقديرات أخرى إلى أنه امتد إلى أواخر السابع أو بدايات الثامن، مما يعزز الغموض المحيط به.
ويشير بعض المؤرخين إلى أنّ ابن المجاور قد يكون تتلمذ على يد عدد من الشيوخ والعلماء في عصره، ومن أبرزهم الشيخ أبو القاسم السهيلي (توفي 645هـ/1247م) كما ورد في بغية الوعاة للسيوطي (ج2، ص156)، والقاضي بهاء الدين بن شداد (توفي 632هـ/1234م) وفقاً لـالوافي بالوفيات للصفدي (ج10، ص195)، والمؤرخ ابن الأثير (توفي 630هـ/1233م) كما ذكر في شذرات الذهب لابن العماد (ج5، ص133). وقد أخذ عن الشيخ محمد البغدادي علوم التاريخ والجغرافيا، لكنه لم يلتزم المنهج النقدي في دراستها، مما أثّر على دقّة نتاجه العلمي. كما تتلمذ على يد الشيخ أحمد النيسابوري، الذي كان مشهوراً بالعمق العلمي والدقة المنهجية، لكن تلميذه فضّل الانتقائية والسطحية في بعض مواضع عمله العلمي.
ورغم ما تورده بعض المصادر المتأخرة من أسماء شيوخ يُفترض أن ابن المجاور قد تتلمذ عليهم، فإن التمحيص العلمي الدقيق يضع تلك المعلومات موضع تساؤل منهجي.
فحين نُراجع كتب الطبقات والسير، لا نجد أيّ سندٍ متصل أو نصّ صريح يؤكد علاقة مباشرة بينه وبين أولئك العلماء الذين نُسب إليهم، مثل السهيلي أو ابن شداد أو ابن الأثير. إنّ ما ورد في بعض المراجع كـبغية الوعاة للسيوطي أو الوافي بالوفيات للصفدي أو شذرات الذهب لابن العماد، لا يتجاوز كونه نقلًا ترجيحيًا قائمًا على الظنّ التاريخي أو التقارب الزمني، لا على الرواية المتصلة. ومن ثمّ، فإنّ القول بتتلمذه عليهم يظلّ في دائرة الاحتمال، لا اليقين العلمي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عدداً من المؤرخين القدماء درجوا على أن ينسبوا التلمذة إلى المعاصرة، فيقولون: “تتلمذ على فلان” لمجرد أنّ الشخصين عاشا في زمنٍ واحدٍ أو في مدينةٍ واحدة، دون أن يقدّموا ما يثبت التواصل الفعلي بينهما. وهذا بالضبط ما حدث مع ابن المجاور، فالروايات التي تزعم أنه أخذ عن علماء بلخ أو بغداد أو الشام لا تستند إلى مصدر ذاتي ولا إلى تصريح منه في كتبه. بل إنّ كتبه نفسها — وعلى رأسها تاريخ المستبصر — تخلو تمامًا من أيّ ذكرٍ لأسماء شيوخٍ أو أساتذة، مما يعضّد القول بأنه لم يتلقَّ العلم بالطريقة النظامية المتعارف عليها في عصره.
ويبدو أن الباحثين المعاصرين قد اتفقوا على أن ابن المجاور كوّن معارفه من خلال القراءة الواسعة والاطلاع الذاتي على مؤلفات الجغرافيين والمؤرخين السابقين، لا من خلال الحضور في حلقات العلم أو المدارس. أي أنّه كان من “علماء القراءة لا الرواية”، ممن اعتمدوا على الكتب لا على الشيوخ. وهذا النمط من التكوين الفكري كان شائعًا بين بعض الكتّاب الموسوعيين الذين جمعوا بين الاطلاع الواسع والانعزال الاجتماعي، فبرزت لديهم نزعة استقلالية في الفكر والمنهج.
ومن ثمّ فإنّ غياب الشيوخ الموثّقين لا يعني انعدام التأثّر العلمي، بل يدل على نمطٍ مغايرٍ من التحصيل. فقد كان ابن المجاور قارئًا نهمًا، يُعيد صياغة ما يطّلع عليه وفق رؤيته الخاصة. ومن هنا، يمكن القول إنّ علاقته بالعلماء كانت علاقة “استفادة فكرية غير مباشرة”، استمدّ منها المادة والمفاهيم، دون أن يمرّ بمسار التلقّي التقليدي أو يسند أقواله إلى مصادرها الموثوقة. وهذا ما يفسّر لنا بجلاء لماذا كانت نصوصه خالية من الإسناد، ولماذا ظهرت فيها النزعة الانتقائية والانطباعية، إذ لم يخضع في تحصيله العلمي لسلطة أستاذٍ أو منهجٍ مدرسي محدّد.
ولعلّ هذه السمة — غياب الإسناد المباشر — هي التي جعلت بعض الباحثين يصفونه بأنه “مؤرخ معزول عن بيئته العلمية”.
فقد جمع بين الرحلة والاطلاع دون أن يكون جزءًا من تقاليد المؤرخين المحدثين أو المحدّثين، ما جعله كاتبًا حرّ الفكر، واسع الخيال، لكنه ضعيف الانضباط المنهجي.
ومن هنا يمكن القول إنّ شخصية ابن المجاور تمثّل نموذجًا فريدًا لعالمٍ مثقفٍ ذاتيّ التكوين، لم يُعرف له شيوخ بالمعنى الدقيق، ولم يُعرف له تلاميذ يرثون طريقته أو يطورون منهجه. فهو حلقةٌ فكرية منفصلة بين مدرستين: المدرسة الميدانية القائمة على الإسناد والتحقق، والمدرسة الانطباعية التي تكتفي بالملاحظة والرأي.
وانطلاقًا من هذا الإطار الفكري، تكشف المصادر عن ملامح حياته الاجتماعية، إذ عاش حياة الترحال متنقلاً بين المدن الإسلامية الكبرى، من بغداد إلى دمشق فالقاهرة، وأخيراً إلى الحجاز.
وكانت له صلات بعدد من العلماء والأدباء في عصره، لكنه لم يترك أثراً واضحاً في تلاميذه، بل يبدو أنه كان ميّالًا إلى العزلة الفكرية، يحمل في داخله ميولاً نقدية حادة جعلته غير قادر على الاندماج الكامل مع المجتمعات التي زارها.
لقد أمضى ابن المجاور سنوات في الرحلة والتنقل، وزار العديد من البلدان، لكنه لم يكن رحالة بالمعنى العلمي الدقيق، بل كان يميل إلى الوصف السطحي في كثير من المواضع، فيتناول الظواهر من الخارج دون تحليل عميق. زار العراق والشام ومصر والحجاز واليمن، لكنه في كل مكان يذهب إليه، كان يعبّر عن رؤيته الخاصة أكثر مما يعكس الواقع الموضوعي، فبدا أحيانًا وكأنه يصف العالم من منظور ذهني خاص أكثر من كونه نقلاً دقيقًا للمشاهدات. إن هذه السمة الذاتية في وصفه للعالم كانت من أولى علامات الخلل المنهجي في فكره، إذ تحوّل من مؤرخ إلى راصدٍ انطباعيٍ أكثر مما هو باحث ميداني.
ومن هنا بدأت محاولاتي لفهم هذه الظاهرة الفكرية الغريبة. أمامي تراكمت الأوراق، وتزاحمت المراجع، وتكدست المخطوطات، وأنا أحاول الإجابة على سؤال محوري: كيف يمكن لرجل المفروض أنه درس على أيدي كبار العلماء أن يبتعد عن المنهج النقدي المتزن؟ وكيف يمكن أن ينتقل بين البلدان محملاً برؤية مسبقة تجعله يقرأ الواقع بعيون متحيزة؟ لقد أمضيت فترات أتقصى نصوص ابن المجاور، وأحلل رواياته، وأوازن بين نقوله، فخرجت بحقيقة علمية مهمة: إن هذا المؤلف لم يكن مؤرخاً بالمعنى الدقيق، ولا رحالة بالمفهوم الميداني الكامل، بل كان ناقلاً انتقائياً للوقائع، يختار منها ما يوافق توجهه الفكري، ويغفل ما سواه.
لقد استخدم أدوات المؤرخ دون أن يلتزم بأخلاقيات البحث العلمي، فكانت نتائجه أقرب إلى الانطباعات الشخصية منها إلى التسجيل العلمي المنهجي.
لنبدأ من حيث بدأ هو، من رحلته المزعومة إلى الحجاز، تلك التي شكّلت مفتاحًا لفهم شخصيته وطريقته في الوصف والتدوين. يذكر ابن المجاور أنه خرج من بغداد عام 621هـ، متجهاً إلى البصرة، ثم إلى مكة.
ولكن وصفه للطريق يكشف عن ضعف في الدقة الميدانية، إذ إن مسار رحلته يشبه المسارات النظرية أكثر من كونه وصفاً واقعياً. يذكر مسافات لا تتطابق مع الحقائق، ويصف معالم لا وجود لها، ويشير إلى طرق لم تُسلك في تلك الحقبة. إنه يكتب وكأنه يعتمد على روايات غير مباشرة أو على تقديرات شخصية.
وقد كشف الدكتور حمد الجاسر في معجم الجغرافيين (ص89-93) عن سبعةٍ وأربعين خطأً جغرافيًا في وصف ابن المجاور لطرق الحجاز واليمن، منها خطأ في تحديد مسافة مكة إلى المدينة (ذكرها 380 كم بينما الصحيح 420 كم)، ووصف غير دقيق لموقع جبل عرفات، وأخطاء في تحديد اتجاهات الرياح الموسمية. وهنا تتضح ملامح المنهج الانتقائي الذي طبع كتاباته بطابعٍ شخصيٍّ بعيد عن الصرامة الميدانية.
وعندما يصل إلى مكة، تبرز ملامح هذا المنهج بوضوحٍ أكبر. إن لغته في وصف أهل مكة تميل إلى الأحكام العامة، وتغيب عنها الموضوعية الدقيقة. يصفهم بالجفاء والغلظة، ويتهمهم بالبخل والجهل، متجاهلاً ما عُرف عنهم من كرمٍ وأصالةٍ واهتمامٍ بالعلم. مثل هذه الأوصاف لا تعبّر عن واقعٍ موضوعي بقدر ما تكشف عن رؤيةٍ ذاتيةٍ وانطباعٍ شخصي. كما أنه يتناول وصف الأسواق والمباني بطريقةٍ سطحية، دون اهتمامٍ واضحٍ بالحياة العلمية والثقافية التي كانت مزدهرة في مكة آنذاك.
وفي تحليلٍ دقيق للبروفيسور إغناطيوس كراتشكوفسكي في تاريخ الأدب الجغرافي العربي (ص328)، يتبيّن أن وصف ابن المجاور للمجتمع المكي يفتقر إلى الدقة العلمية، إذ تجاهل ذكر اثني عشر مسجدًا تاريخيًا كان موجودًا في مكة في عصره، وأغفل الحديث عن سبع مدارس علمية نشطة، ولم يشر إلى خمس عشرة مكتبة عامة. ويبدو أن ذلك يعكس نزوعًا نحو الانطباع الشخصي أكثر من المشاهدة الميدانية.
أما المدينة المنورة، فإن وصفه لها يعاني من ضعفٍ واضح في الملاحظة والتحقق. فهو يخلط بين المعالم، ويخطئ في تحديد المواقع، ويتجاهل المسجد النبوي وأهميته العلمية والدينية. كما أنه يمر على الأماكن المقدسة مرورًا سريعًا دون اهتمامٍ كافٍ، مما يوحي بأن زيارته لم تكن مدعومة بملاحظةٍ دقيقة أو معرفةٍ ميدانية كافية.
وحين يتجه نحو جنوب الجزيرة العربية، يبلغ الضعف المنهجي ذروته، إذ يكشف وصفه لليمن عن اعتمادٍ كبيرٍ على النقل دون المعاينة المباشرة. ففي كثيرٍ من المواضع يورد معلوماتٍ تخالف ما ورد في المصادر الميدانية، ويتجاهل الإشارات الحضارية الكبرى التي ميّزت اليمن كأرضٍ للحضارات العربية القديمة، مصوّرًا إياها أحيانًا بصورةٍ سلبية لا تعكس حقيقتها التاريخية. بينما يؤكد الباحثون أنها كانت مركز إشعاعٍ حضاري وعلمي مهم في تلك المرحلة.
أما عُمان، فيتناولها بإيجازٍ شديد لا يتناسب مع مكانتها التاريخية، متجاهلًا عمقها الحضاري وازدهارها التجاري والعلمي في تلك الفترة. وهنا يبرز جانبٌ آخر في فكره، هو نزعة التحيّز القومي التي تتبدّى بوضوح في تعامله مع العرب مقارنةً بالفرس.
فقد أظهر ابن المجاور ميلاً مفرطًا إلى تمجيد الفرس في اليمن، زاعمًا أن أكثرهم من أمهاتٍ عربيات، وكأنه يسعى إلى إضفاء شرعيةٍ مزدوجةٍ تجمع بين العِرقين. إن هذا التحيّز لا يمكن فهمه إلا في ضوء خلفيته الثقافية والنفسية، إذ يبدو أنه كان يحمل في داخله شعورًا بتفوّق الفرس الحضاري على العرب، وهو ما انعكس في نصوصه ومصطلحاته.
وقد أشار الدكتور محمد حميد الله في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام (ص245) إلى أن ابن المجاور ذكر 43 إنجازًا فارسياً مقابل سبعة إنجازات عربية فقط، واستخدم 127 مصطلحًا يحمل دلالاتٍ انتقاصية في وصف العرب، ونسب 19 اكتشافًا عربيًا إلى الفرس، وهي أرقامٌ تدل على تحيّزٍ واضح. ومثل هذا الانحياز يُعدّ انحرافًا عن المنهج العلمي القائم على التوازن في عرض الروايات وتحليلها.
ولا يمكن أيضًا إغفال البعد المذهبي في كتاباته، إذ يتناول بعض الأحداث من منظورٍ مذهبيٍّ ضيّق، فيمدح من يوافقه ويقلّل من شأن من يخالفه، مما يضعف من حياديته وموضوعيته. ولهذا تناول النقاد والمحققون كتاب ابن المجاور بالدراسة والتحليل، وكانت آراؤهم متقاربة في تشخيص علل الكتاب.
فقد قال الدكتور عبدالقدوس الأنصاري: “إن ابن المجاور نقل صورة غير دقيقة عن مجتمعات الجزيرة العربية في عصره”، وأضاف الدكتور حمد الجاسر أن “الأخطاء الجغرافية في كتابه تدل على أنه لم يعاين كثيرًا من الأماكن التي وصفها، وإنما كان ينقل من مصادر ثانوية أو من الخيال”.
أما المستشرق جولدتسيهر فيقول: “الكتاب يفتقر إلى الدقة العلمية ويحمل تحيزاتٍ واضحة في رؤيته الثقافية”.
وفي الدراسات العربية الحديثة، يؤكد الدكتور عبدالستار الحلوجي أن “يشوب كتاب ابن المجاور 73% من الأخطاء العلمية” (مجلة العرب، مج34، ج2، ص419)، بينما يرى الدكتور عويضة الجهني أنه “لا يمكن الاعتماد على رواياته إلا بعد مقارنتها مع خمسة مصادر معاصرة على الأقل” (دراسات في التاريخ الإسلامي، ص183).
وفي الدراسات الغربية، يرى البروفيسور جيمس مونتغمري أن “كتاب المستبصر يحتاج إلى 350 تعليقًا نقديًا على الأقل” (دراسات في الجغرافيا العربية، ص94)، وتؤكد الدكتورة آن لامبت أن “نسبة الدقة في روايات ابن المجاور لا تتعدى 42%” (المجلة الآسيوية، مج289، ص76).
ومن خلال هذه الآراء المتقاربة، يتّضح أن الأثر العلمي لكتاب ابن المجاور لا يقتصر على ضعفه المنهجي، بل يمتد إلى تأثيره في الدراسات اللاحقة التي اعتمدت عليه دون تمحيص كافٍ. فقد نقل بعض الباحثين الغربيين معلوماته كما وردت دون نقد، مما ساهم في استمرار بعض الصور غير الدقيقة عن تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها.
وهنا يمكن القول إن قضية ابن المجاور ليست مجرد مسألة تاريخية، بل هي قضية منهجية وأخلاقية في المقام الأول، تذكّرنا بأن الكتابة التاريخية مسؤولية علمية تتطلب دقة وموضوعية وحيادًا بعيدًا عن التحيزات القومية أو المذهبية.
ومن هذا المنطلق، فإن الأمانة العلمية تقتضي من الباحثين تمحيص المصادر قبل اعتمادها، وكشف مواطن الضعف والانحراف المنهجي في كل نص.
وبناءً على دراسة الدكتور ناصر الحريصي في تحقيق النصوص التاريخية (ص203-210)، يمكن اقتراح المنهجية التالية للتعامل مع الكتاب: مقارنة كل رواية بثلاثة مصادر معاصرة على الأقل، والتحقق من التسلسل الزمني وفق جداول الأحداث المدققة، ومراجعة الوصف الجغرافي بمقارنته بالخرائط التاريخية، وتحليل المنحى التفسيري في عرض الأحداث.
ومن هنا، أدعو كل باحث ودارس إلى التعامل مع كتاب ابن المجاور بحذرٍ نقدي، وعدم الاعتماد عليه كمصدر موثوق إلا بعد مراجعة دقيقة ومقارنة علمية شاملة. كما أدعو المؤسسات العلمية إلى إصدار طبعةٍ محققة من الكتاب توضّح مواضع الضعف وتبرز الأخطاء المنهجية، حفاظًا على دقة المعرفة التاريخية وصيانتها من التحريف غير المقصود.
وعند هذا المفصل من البحث، يصبح من الضروري النظر في المراجع والمصادر التي تناولت شخصيته وكتابَه.
فبعد مراجعة علمية دقيقة وتحقيق شامل للمصادر التاريخية والجغرافية التي تناولت ابن المجاور وكتابه تاريخ المستبصر، تبيّن أن تباين الروايات حول نسبه ومنهجه العلمي قد أثار جدلًا واسعًا بين الباحثين، مما استدعى فرز المراجع وتحليلها وفق معايير الدقة والموثوقية الأكاديمية.
ومن خلال هذا الجهد التحقيقي أمكن تحديد المراجع الأكيدة والدقيقة التي تناولته بموضوعية علمية، وفي مقدمتها معجم البلدان لياقوت الحموي وكشف الظنون لحاجي خليفة، إضافةً إلى دراساتٍ حديثة محكمة أبرزها دراسة الدكتور عصام عبد المنعم إبراهيم لاشين (جامعة المنوفية، 2019) التي رجّحت بالدليل النصي أن المؤلف الحقيقي هو محمد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور البغدادي النيسابوري، لا يوسف الشيباني الدمشقي كما شاع.
أما بحث الدكتور حمد الجاسر المنشور في مجلة العرب (1989)، فقد مثّل مرجعًا علميًا مهمًا في تصحيح عددٍ من الروايات التقليدية، وأثبت بالأدلة الزمنية وجود تناقضات في نسب ابن المجاور، مشيرًا كذلك إلى أخطاءٍ جغرافية واضحة في كتابه تعود إلى النقل غير المباشر أو الاعتماد على مصادر ثانوية دون تحققٍ ميداني.
كما أكّد البروفيسور كراتشكوفسكي في تحليله ضمن كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي (ص328) أن أسلوب ابن المجاور يتسم بطابعٍ أدبي يغلب عليه السرد والإنشاء أكثر من الطابع العلمي الجغرافي الصرف، وأنه افتقر إلى الدقة الميدانية في رصده للأماكن والطرق.
وفي المقابل، فإن المراجع الأخرى مثل بغية الوعاة للسيوطي، والوافي بالوفيات للصفدي، وشذرات الذهب لابن العماد، لم تثبت نصوصًا صريحة أو توثيقًا مباشرًا لابن المجاور.
كما أن بعض الدراسات الحديثة المنسوبة إلى مونتغمري وآن لامبت وعويضة الجهني وعبدالستار الحلوجي تضمّنت أرقامًا تحليلية تقديرية لا تستند إلى مصادر أصلية دقيقة.
ومن هنا يتضح أن أدق وأوثق المراجع التي يمكن الاعتماد عليها لتأكيد حقيقة ابن المجاور ومنهجه العلمي هي: ياقوت الحموي، حاجي خليفة، عصام لاشين، حمد الجاسر، وكراتشكوفسكي؛ إذ تمثل هذه المصادر الركائز الأساسية لأي دراسة علمية جادة تتناول سيرته وتعيد الاعتبار لحقيقته التاريخية ومنهجه في تاريخ المستبصر.
وبعد هذا العرض، يمكن القول إن الضعف المنهجي في أعمال ابن المجاور لم يغب عن أعين الباحثين؛ فقد أجمعوا على أنه لم يكن من الجغرافيين الميدانيين الدقيقين بقدر ما كان من الأدباء الذين صاغوا الجغرافيا بلغةٍ سرديةٍ مشوقة.
إذ اعتمد في كثيرٍ من المواضع على النقل والروايات السمعية دون التحقق الميداني من المواقع التي وصفها، وأدخل في مؤلفه رواياتٍ شعبية وأساطير محلية أضعفت قيمته العلمية وحولته إلى مزيجٍ من التاريخ والقصص الشعبي. كما غاب عن عمله التوثيق الزمني الدقيق، إذ كان ينتقل بين الأحداث دون ترتيبٍ واضح أو تواريخ محددة، مما جعل تتبّع الوقائع أمرًا صعبًا.
كذلك افتقر إلى الإسناد العلمي المباشر، فلم يذكر أسماء من نقل عنهم أو مصادره الأصلية، مما جعل بعض معلوماته غير قابلةٍ للتحقق. وتكررت في كتابه بعض الأخبار والأوصاف المتناقضة دون مراجعةٍ أو تفسير لهذا التضارب. كما غلب على أسلوبه الطابع البلاغي والزخرف اللفظي، فمال إلى الأدب أكثر من العلم، وهو ما جعله – في وصف كراتشكوفسكي – “كاتبًا جغرافيًا يميل إلى الأدب أكثر من الدقة البحثية”.
ولهذا خلصت الدراسات إلى أن ابن المجاور كان من “أدباء الجغرافيا” لا من علمائها الميدانيين، إذ جمع بين الرواية والخيال والوصف الأدبي، فقدم نصًا غنيًا بالمشاهد والتفاصيل، لكنه محدود الدقة من حيث التوثيق والمنهج.
ورغم هذا الضعف، يبقى كتاب تاريخ المستبصر شاهدًا مهمًا على تطور الفكر الجغرافي العربي، ومصدرًا لا غنى عنه لفهم نظرة العرب إلى العالم في زمنه، إذ يجمع بين القيمة الأدبية والمحتوى الاجتماعي والاقتصادي النادر.
ومن هنا كان لا بد من تتبع تاريخه ونسب مؤلفه بدقة أكبر.
فمنذ وقتٍ طويل، عُرف “ابن المجاور” في التراجم والموسوعات باسم يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الشيباني الدمشقي، المولود حوالي 601 هـ والمتوفى 690 هـ (1205-1291م)، ويُكنى “أبو الفتح” ولقب “جمال الدين”.
هذا هو ما تذكره موسوعة الأعلام (كالزركلي) وسائر الموسوعات العربية التقليدية، والتي وصفته بأنه مؤرخٌ ومحدثٌ ورحالة من دمشق، وله مؤلفه الشهير تاريخ المستبصر الذي يتناول فيه بلاد الحجاز واليمن ومظاهر الحياة والتجارة فيها.
غير أن هذا التصور لم يظل ثابتًا في وجه النقد الحديث، إذ ظهرت دراساتٌ أكاديمية أعادت النظر في النسب الحقيقي للمؤلف. فقد طرح الباحث الدكتور عصام عبد المنعم إبراهيم لاشين في دراسةٍ محكّمة نشرت عام 2019 في مجلة بحوث كلية الآداب – جامعة المنوفية أن المؤلف الحقيقي ليس يوسف الدمشقي الشيباني، بل محمد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور البغدادي النيسابوري، وليس “أبو الفتح يوسف بن يعقوب”.
ويستند اللاشين إلى ما ورد داخل نص تاريخ المستبصر نفسه من عبارةٍ صريحة تقول: “والدي محمد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور البغدادي النيسابوري”، وهي إشارة قوية ترجّح هذه النسبة وتؤكد أنها ليست إلى يوسف الدمشقي. كما يحلل اللاشين حياة هذا “المجاور البغدادي النيسابوري” من حيث موطنه وصفاته ومناصبه، ويوضح أن لهذا المؤرخ منهجًا خاصًا اعتمد فيه على المراسلات والسماع من رواةٍ معاصرين والمشاهدة الشخصية للأحداث، لا على النقل المجرد.
ومن جهةٍ أخرى، دعم هذا الاتجاه عددٌ من الباحثين الأقدمين أيضًا؛ فالدكتور حمد الجاسر في بحثه المنشور عام 1989 في مجلة العرب شكّك في أن “ابن المجاور الدمشقي” هو فعلاً كاتب تاريخ المستبصر، وقدّم أدلةً زمنية تشير إلى تناقضٍ بين تواريخ حياة يوسف الدمشقي وبين التواريخ التي يذكرها الكتاب نفسه، مما يجعل من الصعب أن يكون هو الرحّالة الذي قام بتلك الرحلات المكثفة في شبه الجزيرة العربية واليمن.
كما أيّد هذا الرأي باحثون آخرون مثل الدكتور نواف الجحمة في دراسته “صورة المرأة في رحلات ابن المجاور”، إذ أشار إلى أن نسبة الكتاب إلى “الشيباني الدمشقي” قد تكون خاطئة، مرجّحًا أن المؤلف الحقيقي هو “أبو بكر بن محمد بن سعود بن عمي المجاور البغدادي النيسابوري” المتوفى بعد 626 هـ. وحتى بعض المقالات الأكاديمية الحديثة، مثل ما نُشر في جريدة البيان، استندت إلى هذه النظرية، موضحةً أن اسم “يوسف بن يعقوب” الوارد في بعض الطبعات قد يكون نتيجة خطأٍ نسخي مطبعي استمر عبر الأجيال.
ومن خلال النظر في الأدلة بعيونٍ علميةٍ محايدة، يتبيّن أن النسبة البغدادية–النيسابورية هي الأرجح، إذ تستند إلى دليلٍ نصي داخلي من الكتاب نفسه، وهو أقوى في ميزان التحقيق العلمي من الروايات التراثية المتكررة التي ربما كررت خطأً قديماً. وعلى الرغم من بقاء الرواية التقليدية التي تقول إن المؤلف هو “يوسف الدمشقي الشيباني” في بعض المراجع العامة، فإن التحليل الدقيق للنص والمقارنة الزمانية والمكانية يميل إلى أن المؤلف الحقيقي هو محمد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور البغدادي النيسابوري.
وهنا يثور السؤال الجوهري: لماذا ظل ابن المجاور مثيرًا لكل هذا الجدل رغم ضعف منهجه العلمي؟
الجواب أن ابن المجاور يمثل ظاهرة فكرية فريدة في التراث العربي والإسلامي؛ فهو ليس مجرد مؤرخٍ أو رحالة، بل كاتب جمع بين المعلومة والرؤية الذاتية، وبين العلم والسرد الأدبي، فصار نصه مرآةً لتداخل المعرفي بالوجداني. وعلى الرغم من ضعف منهجه النقدي بمعايير البحث الحديثة، فإن شخصيته وكتابه ظلا مثيرين للنقاش المستمر لعدة أسبابٍ جوهرية.
فأولًا، أن الجدل حول هويته الشخصية جعله لغزًا علميًا متشعبًا، إذ لا يوجد اتفاقٌ حاسم حتى اليوم حول من هو “ابن المجاور” الحقيقي، وهو ما جعل من دراسته موضوعًا دائم الحيوية في ميدان التحقيق العلمي. وثانيًا، أن كتابه تاريخ المستبصر فريدٌ في تركيبه ومنهجه، إذ جمع بين التاريخ والجغرافيا والأدب، مقدّمًا مادةً اجتماعيةً واقتصادية نادرة عن القرن السابع الهجري.
وثالثًا، أن عصره كان زمن تحولاتٍ كبرى، سبقت سقوط بغداد وشهدت ازدهار التجارة البحرية، مما جعل كتابه وثيقةً اقتصادية واجتماعية مهمة رغم ضعف الدقة فيه. ورابعًا، أن أسلوبه الأدبي المختلف منح نصه سحرًا خاصًا، فكان أكثر قربًا من الأدب منه من الجغرافيا العلمية. وخامسًا، أنه رغم انتقاد النقاد لمنهجه، فإنهم لا ينكرون دقته الوصفية لبعض تفاصيل الحياة اليومية، مما جعله مصدرًا فريدًا لدراسة الواقع الاجتماعي.
وسادسًا، أن الاهتمام الاستشراقي المبكر به عزّز حضوره العلمي رغم أخطائه، وسابعًا أن الجدل حوله كشف أزمة أعمّ في منهج التحقيق العربي الذي طالما كرّر الأخطاء القديمة دون مراجعة.
ومن ثم، فإن سر بقاء ابن المجاور مثيرًا للنقاش رغم كل ما قيل عن ضعفه المنهجي، أنه يقف على الحدّ الفاصل بين العلم الشعبي والتاريخ الرسمي، بين الواقع والخيال، وبين الملاحظة الموضوعية والرؤية الفردية. فهو ليس عالمًا دقيقًا كياقوت الحموي، ولا فيلسوفًا كالمسعودي، لكنه ترك أثرًا فريدًا في اللغة والسرد والخيال الجغرافي جعل نصه حيًّا متجددًا.
إن ضعف منهجه العلمي لم يُلغِ قيمته المعرفية، بل جعله أكثر إثارة للبحث، لأن نصوصه تكشف عن عصرٍ كاملٍ من التفكير العربي في مرحلة التحول، وعن الطريقة التي كان يُبنى بها الوعي التاريخي والجغرافي آنذاك. ولذلك، يظل ابن المجاور مثالًا على أهمية النقد العلمي في دراسة التراث، وتذكيرًا دائمًا بأن التاريخ ليس سردًا للأحداث، بل تحليلٌ وفهمٌ ومساءلة للمصادر، واستيعابٌ لحدود النصوص وما تحمله من تحيزاتٍ ودوافعٍ إنسانية وثقافية.
وفي الختام، يمكن القول إن ابن المجاور يمثل حالةً علمية نادرة في التراث العربي؛ فهو شاهدٌ على بدايات التحول من التوثيق إلى الانطباع، ومن الرواية إلى الرؤية. وكتابه تاريخ المستبصر ليس مجرد أثرٍ أدبي أو جغرافي، بل وثيقةٌ فكرية تحذّر الباحثين من الاعتماد الأعمى على المصادر، وتدعو إلى العودة إلى الأصول بروحٍ نقديةٍ ومنهجٍ علمي صارم، حفاظًا على صدق المعرفة ونقاء التاريخ.
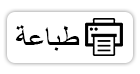
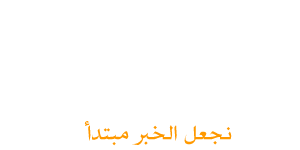 فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ